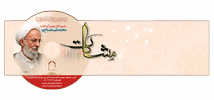- الجلسة الاولي؛ مراتب محبّة الله وشروطها
- الجلسة الثاني؛ محبّةالله في نظر القرآن الكريم
- الجلسة الثالثة: أقسام المحبّة
- الجلسة الرابعة: شدّة المحبّة وضعفها
- الجلسة الخامسة: محبّةالله وحبّ الإنسان لصفات الكمال
- الجلسة السادسة: طريقة لاستجلاب المحبّة
- الجلسة السابعة: آثار المحبّة
- الجلسة الثامنة: الخلوة الليليّة بالله ضروريّة لمحبّته
- الجلسة التاسعة: مناجاة الله إلى جانب التكاليف الاخرى
- الجلسة العاشرهَ: الأعمال المحبوبة عند الله
- الجلسة الحادي العشر: عوامل محبّة الله وموانعها
- الجلسة الثاني عشر: محبّة أولياء الله من لوازم محبتّه تعالى
- الجلسة الثالث عشر: الحمد لله هو ذروة المحبّة
- الجلسة الرابع عشر: العداء لأعداء الله لازم لمحبّته
- الجلسة الخامس عشر: عوامل محبّة الله وموانعها
- الجلسة السادس عشر: سبل تلقّي محبّة الله
- الجلسة السابع عشر: الحبّ في الله
- الجلسة الثامن عشر: إكسير المحبّة
- الجلسة التاسع عشر: درجات محبّة الله
- الجلسة العشرون: مراتب محبّةالله
- الجلسة الإحدي والعشرون: درجات محبّة أهل البيت (عليهم السلام)
- الجلسة الثانية والعشرون: حديث المعراج بحر من المعارف للسير والسلوك
- الجلسة الثالثة والعشرون: الحياة الهنيئة في ظلّ الالتفات إلى الله والتوكّل عليه
- الجلسة الرابعة والعشرون: الحياة الباقية؛ سعي في سبيل سعادة الآخرة
- الجلسة الخامسة والعشرون: الدنيا والآخرة
- الجلسة السادسة والعشرون: الدنيا والآخرة
- الجلسة السابعة والعشرون: الآخرة في النظام العقائديّ والقيميّ للإسلام
- الجلسة الثامنة والعشرون: العوامل الاجتماعيّة وراء سعادة الآخرة، ومهامّ الحكومة
- الجلسة التاسعة والعشرون: خطوةً خطوةً نحو السماء
- الجلسة الثلاثون: العالم هو في محضر الله
- الجلسة الاحدي والثلاثون: الرقيّ التدريجيّ نحو الله
- الجلسة الثانية والثلاثون: المحبّة ثمرة المراقبة
- الجلسة الثالثة والثلاثون: افتح عين القلب وسترى الحبيب
- الجلسة االرابعة والثلاثون: الله هو الذي يربّي السالك إليه
- الجلسة الخامسة والثلاثون: الدنيا؛ هوّةُ هلاك أم سبيلُ تكامل؟
- الجلسةالسادسة والثلاثون: هذا هو العيش الهنيء
- الجلسة السابعة والثلاثون: وصَلَ العبد مكاناً لا يرى - فيه غير الواحد الحقّ الإلٰه
- الجلسة الثمانية والثلاثون: أمارات المحبّة
- الجلسة التاسعة والثلاثون: قلب واحد وحبّ واحد
- الجلسة الاربعون: الفقراءُ الإلهيّون!
- الجلسة الاحدي والاربعون: العلاقة بين الزهد والنهوض الاقتصاديّ
- الجلسة الثانية والأربعون: ثمار عدم التعلّق بالدنيا
- الجلسة الثالثة والاربعون: صفات أهل الدنيا
- الجلسة الرابعة والاربعون: الحياء، أبرز صفات أهل الآخرة
- الجلسة الخامسة والاربعون: نبذ الحماقة
- الجلسةالسادسة والاربعون: حبّ مخلوقات الله
- الجلسة السابعة والاربعون : أهل الآخرة مستيقظة قلوبهم دائم ذكرهم
- الجلسة الثمانية والاربعون : علاقة المحبّة بين العبد والمعبود
- الجلسة التاسعة والاربعون : الحياة لله سبحانه وحده
- الجلسة الخمسون : وحدة الدنيا والآخرة
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
هذا الذي بين أيديكم هو عصارة لمحاضرة سماحة آية الله مصباح اليزديّ (دامت بركاته) ألقاها في مكتب سماحة وليّ أمر المسلمين بتاريخ 13 تموز 2014م الموافق لليلة السادسة عشرة من شهر رمضان المبارك 1435ﻫ نقدّمها من أجل أن تزيد توجيهات سماحته من بصيرتنا وتكون نبراساً ينير لنا درب هدايتنا وسعادتنا.
أمارات المحبّة
38
إشارة
قلنا في المحاضرات الماضية، خلال شرح مقاطع من حديث المعراج، إنّه بعد أن يمتثل العبد الخالص لله أوامر ربّه يحظى بأهليّة أنْ يودِع الله محبّته في قلبه فتظهر عليه، نتيجة لذلك، آثارٌ وبركاتٌ ذكَرنا بعضها في المحاضرة الماضية وسنتطرّق إلى تتمّتها الليلة.
فمن جملة العطايا التي يمنّ الله تبارك وتعالى بها على عبده السالك في هذه المرحلة هي أن يقطع تعلّقاته بكلّ شيء، فلا يعود راغباً في محادثة الآخرين ومجالستهم إلاّ فيما يُرضي ربّه: «حتّى ينقطع حديثُه من المخلوقين ومجالستُه معهم»[1]. ويشير الحديث بعد ذلك إلى ما يصيبه هذا العبد من بركات عند الموت وبعده: «واُنَوِّمه في قبره واُنزِل عليه مُنكَراً ونكيراً حتّى يسألاه ولا يرى غمرة الموت وظُلمة القبر واللحد وهولَ المُطَّلَع»؛ فلا يحسّ بصعوبة نزع الروح، وينزلونه في قبره بهدوء من دون أيّ انزعاج أو وحشة. «ثمّ أضعُ كتابَه في يمينه» يوم القيامة؛ وهي أوصاف ترتبط بعالم الآخرة. ثمّ يقول بعد سرد هذه الخصوصيّات: «فهذه صفات المحبّين» لله. ويبيّن الله تعالى في هذا المقطع من حديث المعراج ما يترتّب في الدنيا والآخرة من نتائج على محبّته جلّ وعلا.
أمارات المحبّة
وهنا، أي في المقطع التالي، يضيف الباري عزّ وجلّ فصلاً آخر يوضّح فيه علامات المحبّين. فليس كلّ مَن ادّعى حبّ الله بمحبّ له حقّاً. فإنّ للعاشق لله علاماتٍ يمكن من خلالها تشخيص حبّه لربّه. بالطبع إنّ محبّة الله هي من لوازم الإيمان؛ إذ أنّ كلّ مَن يؤمن بالله سيعرف أنّ النعم كافّة هي منه عزّ وجلّ وهو سيحبّه لا محالة. لكنّ هذه المحبّة - وبسبب ضحالة المعرفة، أو كمحصّلة لبعض التعلّقات الاُخرى أحياناً – قد لا تنمو، بل وقد تذبل وتتلاشى تحت تأثير أشكال اُخرى من المحبّة. فالإنسان يعلم أنّ جميع ما لديه من نعم هي من عند الله عزّ وجلّ، وهو – لهذا - يحبّ وليّ نعمته، فيبادر إلى شكره والثناء عليه. لكنّ ضعف النفس، أو قلّة المعرفة، أو نقص الإيمان، أو بعض التعلّقات قد تؤدّي بالإنسان إلى التأثّر كثيراً من فَقْد نعمة أو الابتلاء بنازلةٍ ما وهو تأثّر ينسيه عِظَم النعم التي منّ الله بها عليه، وكم أنّ له جلّ وعلا حقوقاً عليه. بل، ومضافاً إلى نسيان محبّته تعالى، فقد يغمر قلبَه – والعياذ بالله – بغض تجاهه عزّ وجلّ. فلعلّنا جميعاً مررنا بهذه التجربة، وهي أنّنا ننسى الآخرين إذا أحببنا أحداً حبّاً شديداً، بل وقد نضَحّي – عند التضادّ والتزاحم – بأشكال المحبّة الاُخرى في سبيل الحبّ الأكبر والأشدّ. من هنا فإنّه ليس لكلّ مَن هبّ ودبّ الأهليّة لأن يودعِ الله جوهرة محبّته في قلبه ويجعل وعاء قلبه طافحاً بعشقه. فإنّ للوصول إلى هذه الدرجة شروطاً خاصّة قد تمّ بيانها في الفقرات السابقة من الحديث. لكن بما أنّ البعض قد يتظاهر بالإيمان بالله وحبّه، فقد خاطب تبارك وتعالى نبيّه الكريم (صلّى الله عليه وآله) في القسم الأخير من الحديث القدسيّ بقوله: «يا أحمد! ليس كلّ مَن قال: اُحبّ الله، أحَبَّني»؛ فليس كلّ من لاكَ محبّةَ الله في فمه بعاشق له حقّاً، اللهمّ إلاّ أن تبدو عليه آثار العشق والمحبّة؛ «حتّى يأخذ قوتاً ويلبس دوناً وينام سجوداً ويطيل قياماً»؛ فالعاشق هو الذي يكتفي من غذائه بما يسدّ رمقه، ومن لباسه بالبسيط، وتخور قواه من طول السجود فيخرّ نائماً، ويطيل قيامه مصلّياً.
يروي آية الله الشيخ بهجت (رحمة الله عليه) أنّ الشيخ الأنصاريّ (رضوان الله تعالى عليه)، ولدى عودته من درسه في يومٍ صيفيّ حارّ في النجف الأشرف، طلب شربة ماء يروي بها ضمأه، فما لبث - في الفترة التي استغرقوها لجلب بعض الماء البارد من السرداب - أن قام إلى الصلاة، فغاص في أعماقها حتّى نسي عطشه، وطالت صلاته حتّى زالت برودة الماء. هكذا هم أحبّاء الله، إنّهم لا يفرّطون حتّى بهذه الفرصة القليلة، فهم يمضونها في الصلاة قائمين بين يدي المحبوب.
انطبقت الشفاه صوماً عن الطعام والكلام
«ويَلزَم صمتاً، ويتوكّل عليّ، ويبكي كثيراً، ويُقلّ ضَحِكاً، ويخالِف هواه، ويتّخذ المسجد بيتاً، والعِلم صاحباً، والزهد جليساً، والعلماء أحبّاء، والفقراء رفقاء، ويطلب رضاي، ويفرّ من العاصين فراراً، ويشتغل بذكري اشتغالاً، ويُكثِر التسبيح دائماً». فمن العلامات الاُخرى للمُحبّ لله تعالى هي أنّه من الساكتين وقليلي الكلام، وأنّ توكّله عليّ، وبكاءه كثير وضحكه قليل، وهو يخالف كلّ ما أمره به قلبه، وأنّ بيته المسجد؛ فهو يذهب إليه ليستريح من عناء الأشغال اليوميّة كلّما أنهكته ليشتغل بالعبادة، وأنّ العلم صاحبه والزهد جليسه، وهو يصطفي أحباءه من بين العلماء وينتقي رفاقه من بين الفقراء، وهو يفرّ من المذنبين فراراً، وهو دائم الذكر والتسبيح لربّه. وقد أمر الله تعالى في بعض آيات كتابه العزيز بتسبيحه؛ كقوله: «وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ»[2]، وقوله: «وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً»[3].
ومن الخصوصيّات الاُخرى لهذا العبد هي أنّه: «يكون بالوعد صادقاً، وبالعهد وافياً، ويكون قلبه طاهراً [لا يضمر ضغينة لأحد]، وفي الصلاة ذاكياً [يحرص على أدائها صحيحة]، وفي الفرائض مجتهداً، وفيما عندي من الثواب راغباً، ومن عذابي راهباً، ولأحبّائي قريناً وجليساً»[4]. فالمحبّ لله تظهر عليه مثل هذه الأمارات. لكنّ السؤال هو: ما هي العلاقة بين هذه العلامات ومحبّة الله؟
القلب الواحد لا يتّسع لحبيبين
نستطيع تقسيم هذه العلامات إلى ثلاث فئات. الفئة الاُولى تتضمّن الاُمور التي تكون علاقتها بمحبّة الآخرين واضحة؛ فالمحبّ يرغب في ذكر أوصاف محبوبه، والاُنس معه، واللقاء به. فالميل إلى عبادة الله، وطول السجود، وكثرة الصلاة لهي من الأمارات الواضحة على محبّة المرء لربّه والرغبة في الاُنس معه والحضور في حضرته. فالذي لا يُكنّ حبّاً لله فهو يؤدّي حتّى صلاته الواجبة بتثاقل وعلى عجل.
والفئة الثانية منها تتّصل باُسلوب التعامل مع الناس، والسلوك الصادق مع الآخرين والالتزام بالعهود. أمّا الفئة الثالثة فتتضمّن أشكال السلوك الفرديّ مثل قلّة الطعام، وبساطة اللباس. لكنّ ارتباط هذه العلامات بمحبّة الله ليس هو بوضوح ارتباط الفئة الاُولى بها. وقد قلنا إنّ الحديث القدسيّ لا يتحدّث عن الحبّ الذي يكنّه الناس العاديّون. فجُلّنا يحبّ الله لِـما أسبغ عليه من النعم. بل إنّنا قد نغفل عن آلاء الله أحياناً فننسى – من أجل ذلك - حبّه، بل ونعاتبه أحياناً اُخرى. لكن ّكلام الباري تعالى في هذا الحديث يدور حول المحبّة التي يمنحها كأجر لمن طوى من عباده مراحل السلوك بجدّ واجتهاد ويجعل قلوبهم طافحة بها. فإنّ من مؤشّرات هذا اللون من الحبّ هي قلّة الطعام وبساطة اللباس.
ولإلقاء الضوء على العلاقة بين الأوصاف المذكورة مع محبّة الله تعالى علينا الالتفات أوّلاً إلى قضيّة أنّ وعاء ابن آدم محدود وأنّ كلّ ما يشغله عن ذكر الله فإنّه يأخذ حيّزاً من قلبه ويبعث على فقدان جزء من حبّه لربّه. فكلّما أضفنا شيئاً إلى الوعاء الذي لا يتّسع إلاّ لِلَتر واحد من الماء فإنّ حجماً مساوياً من مائه سيُراق منه. ومن هذا المنطلق تحديداً فإنّ أيّ عامل يشغل انتباه العبد السالك فإنّه سيسلب منه نفس المقدار من التفاته إلى محبوبه، والحال أنّه لا يرضى بنقصان محبّته لربّه قيد أنملة، اللهمّ إلاّ إذا أراد المحبوب نفسه ذلك. فاللباس الجميل والغذاء اللذيذ مباحان، لكنّهما إذا حالا دون التفات المحبّ إلى محبوبه فسوف لا يطلبهما، فما بالك بالاُمور التي تتعارض مع محبّة الله عزّ وجلّ. فكيف يمكن أن يكون العبد عاشقاً لله ومتعلّقاً به في الوقت الذي يميل طرف من قلبه إلى ما يبغضه محبوبه؟ أليس ذلك شركاً في المحبّة؟ فإذا وصل العبد إلى مرحلة يكون قلبه فيها متعلّقاً بربّه فسوف لا يكون لما يبغضه الله أدنى سبيل إلى قلبه، بل سيفرّ منه؛ فهو سيفرّ من المعصية، ويهرب من موجبات الأنانية، ويحذر من كلّ ما يخلق في نفسه حالة التعلّق بغير الله. فالاكتفاء بالطعام القليل واللباس البسيط، والابتعاد عن أهل المعاصي، والاُنس بأولياء الله، هي من أجل أن لا ينحرف التفات العبد العاشق عن ربّه وأن يكون قلبه طوع أمر محبوبه. وهو لهذا يخالف كلّ ما يطلبه قلبه؛ لأنّ تلبية ما يطلب القلب بمعزل عمّا يريده الباري تعالى هو ضرب من الشرك؛ وهو أن يحبّ اللهَ تعالى وأن يميل إلى هوى نفسه أو يهتمّ بإطراء الآخرين! فإن آل الأمر إلى هذا المآل كان الهوى وإطراء الآخرين صنمين يعبدهما العبد إلى جانب ربّه! وهو ما لا ينسجم مع التوحيد في المحبّة. فإن تعلّق قلب المرء بشخص ما، فينبغي أن لا يرى غيره، وعليه أن يسعى لإلفات انتباهه؛ فلا يجوز أن يكون لقلبه معبود سواه. فإنّ تسلُّل أيّ لون من النزعات الاُخرى إلى قلب العبد هو نوع من الشرك.
تنفيذ كلّ ما يطلبه الحبيب
في موضع آخر من الحديث القدسيّ محطّ البحث يوصَى النبيّ الكريم (صلّى الله عليه وآله) بترك بعض الاُمور: «يا أحمد لا تتزيّن بلِين اللباس وطِيب الطعام ولَين الوطاء»؛ أي لا تزيّن نفسك باللباس الناعم الجميل، ولا تطلب الطعام الطيّب اللذيذ، ولتكتف منه بالمقدار الضروريّ لصحّتك وسلامتك، وتجنّب الفراش الوثير الناعم؛ لأنّ في هذه الاُمور ما تطلبه نفسك. «فإنّ النفْسَ مأوى كلّ شرّ ورفيق كلّ سوء»؛ فالنفس التي تطلب مثل هذه الأشياء هي مكمن الشرّ.
ولطالما أكّد إمامنا الخمينيّ الراحل (رضوان الله تعالى عليه) في كلامه على أنّ جميع المآسي منبعها النفس، فإن عمد الإنسان إلى نفسه فهذّبها فستُحَلّ جميع العُقَد. «فإنّ النفْسَ مأوى كلّ شرّ ورفيق كلّ سوء، تجرُّها إلى طاعة الله وتجرُّك إلى معصيته». فمثل هذا العدوّ يواجه الإنسان. فقد ورد في الخبر: «أعدَى عدوّك نفسُك التي بين جنبيك»[5].
ثمّ يقول: «تطغى إذا شبِعَت، وتشكو إذا جاعت، وتغضب إذا افتقرَتْ، وتتكبّر إذا استغنَت، وتنسى إذا كبِرَت، وتغفَل إذا أمِنَت». فلقد بعث الله تعالى أنبياءه لينذروا الناس حتّى لا يشعروا بأمان زائف، ولكي يلتفتوا دوماً إلى أنّه ثمّة خطر يتربّص بهم وعندئذ لا تستولي عليهم الغفلة.
«وهي قرينة الشيطان، ومثَل النفس كمثَل النعامة تأكل الكثير وإذا حُمل عليها لا تطير، وكمثّل الدِفْلَى لونُه حسَن وطعمُه مرّ»؛ فمَثَل النفس كمثل الزهرة الجميلة والحسنة اللون لكنّها مرّة المذاق. ومن هنا فإنّه يتعيّن على المرء أن يحذر من الاغترار بمظهره المليح، وأن لا يستجيب لشهواته إلاّ بمقدار الضرورة.
فالذي يودّ الإمساك بزمام نفسه عليه أن يأكل القليل، ولا يسعى وراء الزينة، أو يطلب راحة الدنيا. فالنفس البشريّة هي بمثابة الدابّة التي لا ينبغي الاهتمام بها إلاّ في حدود الضرورة والتي يجب استغلالها قدر المستطاع. فإن استجاب المرء لنفسَه في دلالها وتغنّجها فسوف لا يستطيع امتطاءها. فزمام النفس هو الذي ينبغي أن يكون في يد صاحبها، لا أن يكون المرء تحت تصرّف نفسه وطوع أمرها.
فالذي لا ينفكّ عن التفكير في الطعام اللذيذ واللباس الحسن لا تُستساغ منه دعوى محبّة الله عزّ وجلّ، فمحبوب شخص كهذا هو لباسُه وبطنُه. كما أنّ المحبّ لا يغيب اسم محبوبه عن لسانه، إلاّ لبعض الاعتبارات. فالذي يموج قلبه حبّاً لله يكون دائم اللهج باسمه تعالى، والإطراء عليه، والسعي في القيام بكلّ ما يحبّه ويرضاه. فإن أصبح المرء هكذا، عُلِم حينئذ أنّه يحبّ ربّه حقّاً.
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين
[1]. بحار الأنوار، ج74، ص28.
[2]. سورة آل عمران، الآية 41.
[3]. سورة الأحزاب، الآية 42.
[4]. إرشاد القلوب، ج1، ص206.
[5]. عدّة الداعي ونجاح الساعي، ص314.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org